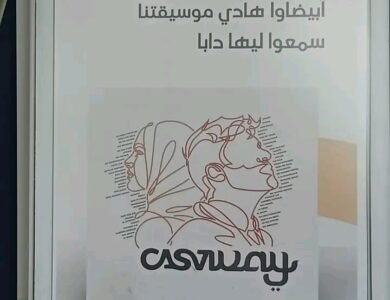عبد الحميد أبوزرة/ باحث مغربي
في هذه العطلة، قررت أن أمتنع عن نشر أي صور أو مشاهد من حياتي اليومية، عن عمد، لأستعيد جزءًا من ذاتي وذواتنا من قبضة وسائل التواصل الاجتماعي التي سلبتنا حريتنا، واستبدلت حياتنا الحقيقية بحياة سائلة افتراضية، تختصر الواقع إلى إشارات وصور، وتحوّل الزمن إلى لحظات استهلاكية بلا معنى.
في المنزل القروي الجبلي، الذي أعتزل فيه عن صخب العالم ونفاقه، وقع بصري على مشهد بسيط لكنه عميق في دلالاته: قطة أم تنقل صغارها من كومة القش إلى داخل المنزل. لم يكن هذا مجرد نقل عادي؛ فالقطة، رغم إغلاق الباب عليها ومنعها، تعض على رقبة صغيرها بعنف حنون، وتنطلق به محمولة بالإصرار والحرص، محاولةً مرارًا وتكرارًا إيصال صغارها إلى المكان الذي اعتبرته آمنًا.
تساءلت حينها: ما الدافع الذي يجعل القطة تكرر هذا الفعل؟ ما الذي يجعلها تُصرّ على نقل صغارها ضد كل عائق؟
قادني الفضول إلى سؤال برنامج الذكاء الاصطناعي عن هذا المشهد، وكانت الإجابات كما توقعت: الغريزة، الهرمونات، التطور البيولوجي الذي منح الثدييات القدرة على رعاية صغارها. شرح منطقي، علمي، قابل للقياس، لكنه ناقص تمامًا، عاجز عن فهم ما أراه أنا: تلك اللحظة الحية، ذاك العنف الحنون، ذلك التوق للحماية، تلك الحرية التي تحيا بها القطة وصغارها.
هنا أذكر حادثة شهيرة ذكرها عبد الوهاب المسيري، والتي كانت سببًا في تحوله من ضيق المادية إلى رحابة الإنسانية: استيقظ هو وزوجته ذات صباح على صراخ طفلتهم الرضيعة، الذي استمر بلا توقف حتى حملتها زوجته فتوقفت عن البكاء. تساءل المسيري حينها: هل الحياة مجرد هرمونات وتفاعلات كيميائية، أم هناك شيء أكبر؟ هذه الحادثة تذكّرنا أن هناك في الحياة تجارب ومشاعر لا يمكن اختزالها في معادلات أو نماذج، مهما بلغت دقتها أو تعقيدها.
فالذكاء الاصطناعي، مهما بلغ من قوة، لن يعرف معنى الفرح، ولا الرحمة، ولا الأمل، ولا تجربة الموت، ولا نقل الحياة. لن يعرف أبدًا ما يعنيه أن تُحب، أن تخاف على صغير، أن تحمي كينونة حية أخرى. لأنه ببساطة لم يسبق له أن خاض تجربة الحياة كما يعيشها الكائن الحي.
أما وسائل التواصل الاجتماعي، فهي لا تقل قسوة عن الخوارزميات؛ فهي تجعلنا رهائن الإشعارات، تُقحم حياتنا في صور وصدمات مستمرة، وتحوّل تجاربنا الحية إلى مقتطفات استهلاكية. انتقد الفلاسفة وعلماء الاجتماع هذه الظاهرة بشدة، موضحين أنها تعزز التركيز على الصورة الذاتية على حساب التجربة الحقيقية، وتحوّل الفرد إلى سلعة اجتماعية. كما أنها تضعف مفهوم الذات، وتفرض معايير جمالية غير واقعية، وتغذي النزعة الأنانية والانغلاق على الذات، وتدفع الناس إلى تزييف واقعهم، والاعتماد على ردود الفعل الرقمية بدلًا من التواصل الحقيقي. إنها تضخم ثقافة الانكشاف والمراقبة الذاتية، وتحوّل الحياة اليومية إلى أداء مستمر أمام جمهور افتراضي، فتشتت الانتباه عن اللحظات الحية وتضعف جودة التجربة الإنسانية.
وهنا يظهر الفرق الجوهري بين عالمنا المادي المبرمج بالقوانين والخوارزميات وبين الحياة نفسها، التي أعقد وأجمل وأروع من كل المعادلات. الحياة لا تُقاس بالمعلومات، ولا تُستوعب بالنماذج. هي أوسع، أعمق، وأقوى من أي نموذج رقمي يمكن للإنسان أن يصممه.
إن القطة التي تصر على نقل صغارها، وحادثة بكاء طفلة المسيري، هما رمزان لكل كائن حي يرفض أن يُحشر في نماذج افتراضية أو قيود رقمية. إنها دعوة صامتة لنا لنخرج من سجون العبودية الرقمية، لنحيا حياتنا الحقيقية، بآلامها وفرحها، بقراراتها العميقة، وبحرية لا يمكن لأي خوارزمية أو شاشة أن تفهمها.
لأن الحياة، في جوهرها، أعمق من كل ما نستطيع قياسه، وأجمل من كل ما نستطيع اختزاله.